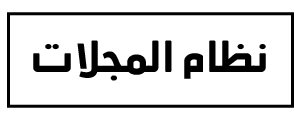سيمياء الضريح في الوقوف بين السموات ورأس الامام الحسين عليه السلام
الكلمات المفتاحية:
سيمياء الضريح في الوقوف بين السموات ورأس الامام الحسين عليه السلامالملخص
دأبَ هذا البحثُ نحوَ الكَشْفِ عن ملامحِ سَمْيَأَةِ الضَّرِيح الحُسَيْنِيِّ في الشِّعْرِ العربيِّ الحديثِ بصفتِه - أي الضَّريح - رَمْزًا لخلودِ صاحبِه، وانتصارًا لكُلِّ القِيَمِ الإنسانيَّةِ النبيلةِ؛ على الرَّغم من إراقةِ دماء صاحبِه الزَّكِيَّةِ على أرضِ الطُّفُوف.وقد اتَّخذَ لهذه الغايةِ - الَّتِي رآهَا جديدةً - نصَّ (فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَرَأْسَ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ) للشَّاعرِ العِراقيِّ (مُظفَّر النَّوَّاب) نموذجًا؛ إذ قد بدَا فيه بوضوحٍ إصرارُ الشَّاعرِ على جَعْلِ الضَّرِيح (أيقونةً) للفداءِ النَّبيلِ والثَّبات على الحقِّ أمامَ جحافلِ الباطلِ. وقد استطاع من خلال اتخاذ الضَّريح أيقونة أن يُدِينَ الجُبْنَ العربيَّ الرَّسْمِيَّ ، الذي ارتضى الجلوسَ على بَيْضِ المفاوضاتِ البليدةِ، وأخذ يَتَشَبَّثُ بنصوصٍ سياسيَّةٍ بائسةٍ، فَوَقَفَ عاجِزًا - لسنينَ طويلةٍ - أمام حِصار فِلَسْطين واحتلال أراضيها وتقسيمها إلى ضِفَّةٍ وقطاعٍ وما إلى ذلك من كلمات بذيئةٍ تتصدر ألسنة الإعلام العربيِّ، كما استطاع من خلاله أن يدين تخاذلَ دُولِ العالم العربيِّ لنُصْرَةِ العِراق وقد حاصرته جيوش الاحتلالِ، ثم تَرْكِه مُمَزَّقًا مُتشرذِمًا. رابطًا بذلك بين كَرْبلاء وفِلَسطين من جهة الْحِصَار والموت عَطَشًا وجوعًا، وبين الحُسَيْن يوم الطفوف.والعراق يوم الحرب الأمريكية من جهة الوقوف والثبات على الموقف.لقد مثَّل الضَّريحُ الحُسيْنِيُّ - في هذا النصِّ الفريدِ - خَطًّا عموديًّا سيميائيًّا اخترق الخطوط العرضية الأخرى المكونة له، وهي خطوط المعجم والتراكيب والضمائر والأساليب والإيقاع العروضيِّ والإنشاديِّ.وقد تحرَّك الضريحُ فيه ثلاثَ حركاتٍ؛ كان أوَّلها:الضريح بصفته أيقونة العتبة الحُسينيَّة المُقدَّسة، وفيه تجسَّد الضريح مكانًا سماويًّا (في السموات) يوازي - عند الشاعر - قداسة بيت الله الحرامِ في مكَّة، والذي ولد هذه الصِّلة هو أن صاحب الضريح a حفيد النبي ، وعاش في كنف ينابيع الوحي.أما الحركةُ الثانيةُ:فقد تمثَّلت في الخيالِ الشِّعريِّ؛ إذ قد اندمج الشَّاعر قلبًا ورُوحًا وعقلًا في المَشْهَد الحُسَيْنِيِّ، فتبلَّجَ قُفْلُ الضَّريح، وخرج الحُسَيْنُ منه أكثر حياةً، وأكثر قُوَّةً، لم ينل منه أعداؤه شيئا؛ كرامة لنسبه الشريف (أَلَسْتَ الْحُسَيْنُ ابْنُ فَاطِمَةٍ وَعَلِيٍّ؟ لِمَاذَا الذُّهُولْ). أمَّا الحركةُ السِّيميائيةُ الأخيرة للضَّريح فقد كانت ممزوجة بالهَمِّ الوطنيِّ، فكما حُوصِر الْحُسَيْنُ وعُطِّشَ وقُتِلَ وتَمَزَّقَ، حُوصِر العِراقُ حصارًا اقتصاديًّا عنيفًا وجُوِّعَ أبناؤه، وقُوتِلَ، وتُرِكَ مُمَزَّقَ الأوصالِ.يتقاطع الضريحُ مع مكونات النصِّ الأخرى، فيبدو مؤثِّرًا على اختيار الشاعر لمفرداته المعجمية، فتظهر مفردات معجمية مثل:الماء، كربلاء، فلسطين.كما تظهر مفردات من عالم الهجاء:يزيدٍ (بالإجراء)، والخصاء، وقراد الحلول، والكلاب.كما ألقى الضريح - بصفته الإشارية - بظلال على اختيار الشَّاعر للتراكيب النحوية، فتوقف عند الجملة الافتتاحيَّة الأولى، التي طالت كدفقةٍ شعريَّةٍ شُعُوريَّةٍ ربطت بين الضَّريحِ الحُسَيْنِيِّ وبيت الله الحرام (وَالْحَمَائِمُ أَسْرَابُ نُورٍ أَتْرَعَتْهَا يَنَابِيعُ مَكَّةَ أَعْذَبَ مَا تَسْتَطِيعُ).هذا، وقد كان استحضارُ ((مُظفَّر)) للإمام الحُسَيْن في النصِّ استحضارًا مُباشرًا عن طريق ضمير المُخاطَب، الذي حافظ به على الملامح التراثيَّة لشخصية الإمام، مُسْتغِلًّا هذه الملامح في توليد المفارقة بين هذه الملامح وبين الجانب المعاصر.وعلى جانب آخر بدا من خلال التحليل السيميائيِّ للضَّمير في هذا الجزء، أنه مثلما يبحث الضَّمِيرُ عن مرجعيَّةٍ لغويَّةٍ، وهي في النصِّ (الحسين) - أي إن الحُسَيْنَ هو مركز النصِّ الذي ترجع إليه الضمائر المخاطبة - فإن الضَّريح الحسيني هو مرجع (الضمائر) السَّوِيَّة والنفوس الزَّكية صاحبة القيم النبيلة والثبات بقوة على الحقِّ.ولما كان استدعاء الضَّريح استدعاءً عن طريق ضمير المخاطب، بدا في النص الفعل الإشاريُّ للأساليب الإنشائيَّة، إذ قد اعتمدَ الشَّاعرُ على الأساليب التي تستحضرُ المُخاطب أمامها، وخاصَّةً أسلوبَ الاستفهام، وأسلوب النداء.أي إنَّ استخدام الأساليب في النصِّ جاء في فَلَكِ الضَّريح وصاحبِه أيضًا.ولمَّا كان الضَّريحُ خَطًّا إشاريًّا عموديًّا يخترقُ الخُطوطَ العرضيَّةَ الأُخْرى للنصِّ، بدا تأثيرُه الأيقونيُّ على الوزن والنِّظام التفعيليِّ، والقافية، والإلقاء الشَّفويِّ.إذ قد جاء في وزن المتقارب ذي التفعيلة البطيئة المكونة من مقطعَيْن صوتيِّيْنِ طويلَيْنِ ومقطعٍ واحدٍ قصيرٍ، أي إنَّ نِسبة البُطْء فيه (2:1)، وهذا البُطْءُ الكمِّيُّ يولد إيقاعًا كإيقاعِ قَرْعِ الطُّبُول الذي يأخذ بالقلبِ نحو الترقُّب والقلق والتوتُّر.واضعًا المتلقِّي في جوٍّ مشحونٍ بأصداء السُّيوف وصهيل الخُيُول، كما بدا في قوله: (وَلَمْ يَكُ أَشْمَخَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَدُوسُ عَلْيَكَ الْخُيُولْ)، وقوله: (إِذِ الشَّرُّ يُعْلِنُ دَوْلَتَهُ بِالطُّبُولِ).ويشارك النِّظاُم التفعيليُّ في سَمْيَأَةِ الوزنِ فتأتي التفعيلاتُ الكاملة معادلًا دلاليًا على اكتمال المكيدة وإحكام دائرة القتل، وتمزيق كامل الجسد الحسينيِّ الشريف.كما بدا من خلال تفعيلتي: (عَلَيْكَ لْ)، و(ته باطط) في كلمتي (دَوْلَتَهُ بِالطُّبُولِ).وكما كان للوزن والنظام التفعيليِّ عملُهما الإشاريّ، بدا بوضوح عملُ القافية أيضًا؛ إذ اعتمد الشَّاعرُ على صوت رَوِيِّ اللَّام السَّاكنة، التي يلتصقُ طرف اللِّسان بسقفِ الحَنَك حين النُّطْق بها ، مولِّدًا دلالةَ الالتصاق بأركان الضَّريح والتشبث بها استلهامًا للقُوَّة من صاحب الموقف الفَذِّ، بدليل قوله: (تَعَلَّمْتُ مِنْكَ ثَبَاتِي وَقُوَّةَ حُزْنِيَ وَحِيدًا).ولما كان نصُّ (فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ السَّمَواتِ)نَصًّا مُنْشَدًا في الأصل، فقد صارَ لِزَامًا على الباحث إن يتصدَّى لعناصر الإيقاع الإنشاديِّ للنَّصِّ، فدرس النَّبْر بصفته مقطعًا مُميَّزًا صوتِيًّا عن سائر مقاطع الكلمة، ودرس عُلُوَّ الصَّوْت وشِدَّته، كما درس دَوْرَ التنغيم في تِبْيَانِ الانتقال من معنًى إلى آخرَ في النِّصِّ، أو بالأحرى من حركةٍ إشاريَّةٍ إلى حركةٍ إشارِيَّةٍ أخرى.وفي خُطْوَةٍ أخيرةٍ في هذا الجُزْءِ الصوتيِّ تَمَّتْ دراسة دور البَحَّة الصَّوتيَّة عند ((مُظفَّر)) في إنتاجِ دلالاتِ الحُزْن والتوجُّع والتألُّم على صاحب الضَّريحِ، والعِراق، وفِلَسطين والوطن العربيِّ.